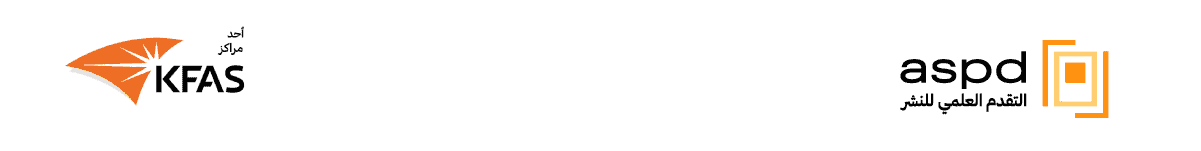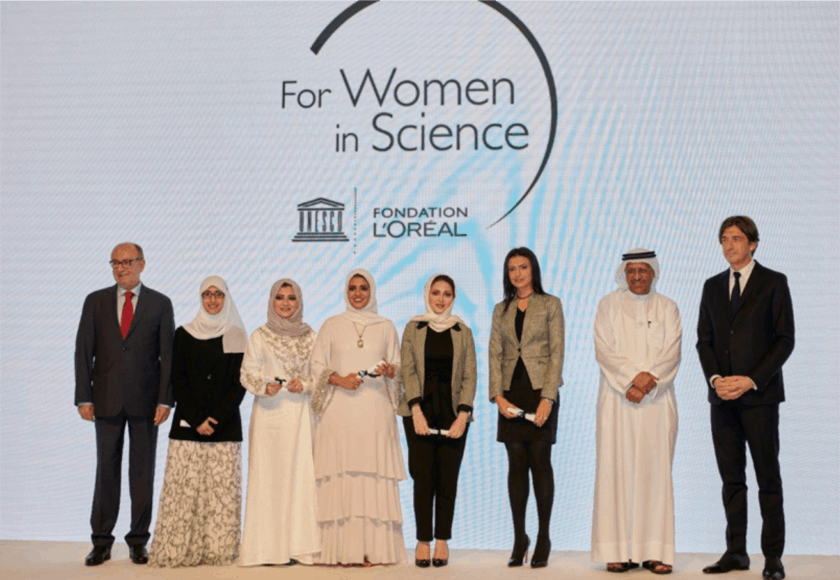بروز الأخلاقيات البيولوجية
2013 لمن الرأي في الحياة؟
جين ماينشين
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
عندما ولدت لويز براون عن طريق الإخصاب في المختبر، أبدت وسائل الإعلام لهفة في الحصول على الأخبار، لكن العمل كان قد أنجز.
هناك الوليدة المعافاة والسوية والسعيدة مع والديها السويين والفرحين، ما يثبت أن ولادتها لم تكن عملاً شرّيراً. ربما يتساءل أحدهم، كيف يمكن أن تظهر تحدّيات جدية لأخلاقيات جلب مثل هذا الطفل إلى العالم؟
كما أننا كنا ساذجين في موضوع الأخلاقيات البيولوجية في ذاك الوقت. لم يكن هناك جماعة مدرّبة من الخبراء في الأخلاقيات البيولوجية مستعدّة للانقضاض على كل قضية من قضايا البيولوجيا والطبّ وتحليل عواقبها الأخلاقية من جميع الجوانب.
لكن في سنة 1997 كان يوجد مثل هؤلاء، ويوجد مجال لمناقشة الملاءمة الأخلاقية لاستنساخ البشر. لم يكن هناك أي وليد سعيد بعد. فالوجه الهادئ للنعجة، بصرف النظر عن جاذبيته الظاهرة، لم يثر الشعور الفوري نفسه بأن "ذلك أمر جيد لنا نحن البشر".
يعود السبب الجزئي لنشأة كادر اختصاصيي الأخلاقيات البيولوجية إلى برنامج إلسي (الآثار الأخلاقية والقانونية والاجتماعية) ضمن مشروع الجينوم البشري، فقد قدّم المشروع المال إلى الباحثين الذي يتناولون قضايا الأخلاقيات البيولوجية ويدرّبون آخرين في الأخلاقيات البيولوجية المتصلة بقضايا الوراثيات والجينوميات.
بيد أن هناك أسباباً إضافية لنشأة الأخلاقيات البيولوجية إلى جانب الفرص التي أتاحها تمويل إلسي. في سنة 1947، أفضت محاكمات نورمبرغ إلى مدوّنة سلوك ترشد البحوث الطبية على البشر وتحظر "التجارب" على البشر مثل تجارب النازيين التي تنتهك الكرامة الإنسانية وحقوق الفرد بوضوح.
وقد طوّرت الجماعات الطبية المختلفة في العديد من البلدان مدوّنات سلوك أخلاقية خاصة بها. ومن المبادئ التي صمّمت لحماية الأفراد من إساءة المعاملة مطلب ألا "تفوق الأخطار البتة ما تحدّده الأهمية الإنسانية للمشكلة التي تحلّها التجربة".
في ستينات وسبعينات القرن العشرين، تابعت "معاهد الصحة الوطنية" النقاشات بشأن حماية البشر المشاركين في الأبحاث والتجارب الطبية. لم يكتفِ هذا الاتجاه البحثي بالعواقب المطلقة للسياسات فحسب، وإنما المخاوف العملية على "معاهد الصحة الوطنية" أيضاً، عندما أخذ باحثوها يجرون مزيداً من البحوث في مركزهم الأم في بثيسدا، مريلاند.
وفي سنة 1974، أصبح مرسوم البحوث الوطني قانوناً، وأنشئت بموجبه اللجنة الوطنية لحماية البشر من الأبحاث البيولوجية الطبية والسلوكية. وشمل تفويض اللجنة "المبادئ الأخلاقية الأساسية التي يجب أن يقوم عليها إجراء الأبحاث البيولوجية الطبية والسلوكية التي تشمل البشر" ووضع "المبادئ التوجيهية التي يجب اتباعها لضمان إجراء مثل هذه الأبحاث بالتوافق مع تلك المبادئ".
تلا ذلك ما أصبح معروفاً باسم تقرير بلمونت (Belmont) الصادر عن مؤتمر عقد مركز مؤتمرات بلمونت التابع لمعهد سميثسونيان. قدّم هذا التقرير مجموعة من المبادئ التوجيهية وإطاراً لمزيد من المنقاشات بالإشارة إلى المبادئ الأخلاقية الأساسية. يجب أن يبدأ أي إجراء من أساس متين: "ثمة ثلاثة مبادئ أساسية، من بين تلك المقبولة على العموم في تقاليدنا الثقافية، ذات صلة خاصة بأخلاقيات الأبحاث التي تشمل البشر: مبادئ احترام الأشخاص والإحسان والعدالة".
جلب 18 حزيران/ يونيو 1991 تعاوناً غير عادي في واشنطن، عندما اشتركت أغلبية كبيرة من الهيئات الاتحادية في نشر "قانون مشترك" لتنظيم السلوك ودعم الأبحاث في الحكومة بأكملها. وقد وفّر هذا القانون إطاراً لإقامة مجالس مراجعة مؤسسية داخلية على سبيل المثال.
ومنذ ذلك الحين أوضحت مختلف المراجعات التي تهدف إلى تفسير القواعد وتوسيعها بعض الجوانب، في حين بقيت قواعد أخرى تقع خارج الولاية القانونية الواضحة للهيئات مفتوحة أمام التفسير. ويقع الاستنساخ ضمن الفئة الأخيرة.
إن تقييم ما يعتبر أخطاراً مفرطة أو الطريقة الفضلى لضمان المحافظة على المبادئ الأخلاقية الأساسية هو الأمر المنظور فيه بالضبط في معظم القضايا الأخلاقية البيولوجية المتنازع عليها. ما الذي يجب أن نفعله بتزايد معرفتنا عن الجينوميات وهل يجدر بنا تجربة المعالجة باستبدال الجينات أو المعالجة بتعزيز الجينات أو بالخلايا المنتشة ومتى: هذه جميعاً أسئلة مثيرة للتحدي. متى قد يثبت أن الاستنساخ ذو فوائد كافية تفوق الأخطار، ومتى تسود الأخطار؟ لقد بدأنا في الولايات المتحدة الاعتماد على الأخلاقيات البيولوجية لمساعدتنا في اتخاذ القرارات.
ربما يكون آرثر كابلان (Arthur Caplan) ، مدير مركز الأخلاقيات البيولوجية في جامعة بنسلفانيا من أشهر خبراء الأخلاقيات البيولوجية في أوساط الجمهور. لكن النقّاد يسخرون من استعداد كابلان الظاهر للتعبير عن الرأي في موضوعات واسعة جداً، ويضحكون من رؤيته في العديد من محطات التلفزة في آن معاً.
ويقولون هازئين إن "العلماء الحقيقيين" يجب ألا يكونوا شعبيين جداً. بيد أن المواطنين العاقلين يجب أن يقرّوا بأن كابلان أبدى استعداداً لتناول المسائل الأخلاقية الصعبة عندما أحجم الآخرون. وقد ساعد في تطوير برامج تعليم الخرّيجين، وتدريب اختصاصيي الأخلاق على التحدّث إلى الصحافة والجمهور، ورأى أن على اختصاصيي الأخلاقيات البيولوجية أن يدرسوا العلم والآثار الطبية التي يتحدّثون عنها قبل أن يبدؤوا الكلام.
ربما يظهر في كل محطات الأخبار بين الحين والآخر، عندما تبرز قضية ساخنة، وأصبح موقعه الإلكتروني في موقع جامعة بنسلفانيا يستقبل 17,000 زيارة في اليوم بدلاً من 500 في الشهر قبل مجيء دولي. وذلك ليس شيئاً سيّئاً بالضرورة. إذا كان الجمهور، والمراسلون، والعلماء، والقادة الدينيون، والمعلّمون، وسواهم من العلماء متلهّفين للحصول على إجابات لأنفسهم، أو لجمهورهم، أو ناخبيهم، أو أبناء أبرشيتهم، أو طلابهم، فإنه لأمر حسن أن يبذل أحد الجهد لتلبية التعطّش إلى الفهم بقدر ما تمكّن الاستقامة والخبرة من ذلك.
إننا جميعاً نريد أن نعرف عما يدور عليه العلم، وكذلك ماذا يعني. ويقوم كابلان واختصاصيو الأخلاقيات البيولوجية الرائدون الآخرون في المراكز في جميع أنحاء البلد بأداء خدمة في التقدّم لمساعدتنا في الحصول على رؤية للموضوع.
الإشكالية الأكبر تكمن في من يزعمون أنهم اختصاصيون في الأخلاقيات البيولوجية واللاهوتيون الذي تحوّلوا إلى اختصاصيين في الأخلاقيات البيولوجية، وهؤلاء يدلون بأصواتهم في المزيج رداً على التصوّرات الشعبية "للمشاكل" التي يحدثها العلماء. وكثير من هؤلاء الدعاة لا يبدون استعداداً جاداً للتأمّل في التحديات الصعبة للتمييز بين الصواب والخطأ.
وبدلاً من ذلك يبدؤون باعتقادات مسبقة بشأن ما يجب أن تكون عليه النتائج. ويحملون أفكاراً معيّنة يريدون الترويج لها، سواء أكانت ردود فعل تلقائية، أو معتقدات عميقة مطلقة، أو سوء فهم. ويظهر بعضُهم عدمَ اهتمامٍ مقصوداً في تعلّم المزيد عن العلم أو التجارب الطبية.
ويصرّ من يزعمون أنهم اختصاصيون في الأخلاقيات البيولوجية على أنهم يعرفون ما هو حقّ وصواب وخير، وأنهم سيكرّسون أنفسهم في الدعوة أياً تكن الظروف. وهذا أمر مزعج. لكن هذا ما يمكن أن تقودنا إليه "حكمة النفور" الموجودة لدى ليون كاس، رئيس مجلس الأخلاقيات البيولوجية الذي عيّنه الرئيس الأميركي، لأنه يعتمد اعتماداً شديداً على حدسه وافتراضاته بأن حدسنا يجب أن يتطابق مع حدسه وإذا لم يتطابق فثمة خطأ فينا.
غالباً ما يواجه دعاة الحدسية مشكلة عند هذه المرحلة بالضبط. فهم يعتمدون على البداهات الذاتية المشتركة بمثابة مصدرهم لليقين ونوع من الحقيقة. بيد أن التاريخ يكشف أن يقيننا المفترض بشأن النفور يستبدل القبول به في مرحلة لاحقة. وغالباً ما يستند حدسنا إلى الأهواء التي تنشأ من الخبرات المحدودة وقيمنا السياقية الخاصة.
يمكن أن يوفّر الحدس نقطة انطلاق مفيدة لمزيد من التأمّل، لكنه يكون أساساً رديئاً للسياسة الاجتماعية عندما يقود إلى التشدّد والاستبداد ومقاومة المراجعة في ضوء الأدلة الجديدة. لذا علينا أن نتعلّم من التاريخ بأن الاعتماد على الحدس بمثابة مرشد للسلوك الأخلاقي ينافي الحكمة. الطبيعة تتطوّر، والعلم يتطوّر، والمواقف الاجتماعية تتغيّر، ويجب أن نتوقّع أن تختلف استجاباتنا.
هذا ليس المكان المناسب لتكرار كل ما كتب عن القضايا الأخلاقية التي أثارها الاستنساخ. فهناك كثير من الكتب في المكتبات تخبرك بأكثر مما أردت أن تعرفه عن جميع أفكار اختصاصيي الأخلاقيات البيولوجية في هذا الموضوع.
بل إن العديد من الكتب المحرّرة تضمّ المقالات نفسها للأشخاص أنفسهم، لأنه يعتقد أن وجهات النظر هذه مفيدة جداً وقابلة للتسويق بحيث تحتمل تكرارها أمام جمهور مختلف. ويعكس هذا العرض للاهتمام بأخلاقيات الاستنساخ ارتفاع عدد اختصاصيي الأخلاقيات البيولوجية بالإضافة إلى تزايد دورهم العام في المجتمع.
تقع أهم الأسئلة في عدة مجموعات. تأتي أولاً الأسئلة التي تتناول قضايا الاستقلال والشخصانية والفردية والكرامة الإنسانية. يقول اختصاصيو الأخلاق إنه إذا كانت النسيلة نسخة وراثية من الخلية المانحة، فإنها لن تكون فرداً؛ ولن تتمتع بالاستقلال، وبالتالي تحرم من الكرامة الإنسانية.
بيد أنه كما أشير سابقاً، فإن ليونتين وغيره أشاروا بوضوح إلى أن ذلك هراء لأن "التنسّخ ليس إنجاباً". بل إن النسيلة ليست نسخة طبق الأصل عن أي شيء باستثناء أن الجينات النووية متماثلة فعلياً مع جينات المانح. أضف هذه إلى الجينات الأخرى لخلية البيضة المضيفة، وامزجها مع جميع العمليات التطوّرية والتغيّرات البيئية، وستكون الذرية مختلفة تماماً.
سرّ المعلّقون في الإشارة إلى أن النسيلة ستكون أقل شبهاً "بوالدها" من شبه التوأمين أحدهما بالآخر. في جلسة استماع مقنعة في الكونغرس في أوائل سنة 1997، أشار مدير "معاهد الصحة الوطنية" هارولد فارموس إلى أنه أحد توأمين ذكرين.
وقد أكّد هو وشقيقه أنه ما من فردين، بل حتى توأمين متماثلين، متشابهان حقاً. ففي النهاية، كما أخبرنا، كان هو رئيس معهد أبحاث كبير في الولايات المتحدة، في حين أن أخاه رئيس معهد أبحاث كبير في كندا. وقال ممازحاً إن ذلك مختلف جداً. وبعد أن اجتذب انتباه الجمهور المحتشد، حاول أن يبين بعناية أن النسائل ليست نسخاً ويجب ألا ينظر إليها على هذا النحو.
مع ذلك، فإن الاستنساخ يسبّب مشاكل للملتزمين بالتفسير بأن الحياة البشرية تبدأ عند الحمل – وهو حدث يرى كثيرون أنه يشتمل على دخول الروح. متى تحصل النسيلة على الروح؟ متى تبدأ الحياة: هل وضع نواة أو خلية المانح في المضيف يكافئ لحظة الولادة، وبالتالي بداية للحياة؟
في عيادات الإخصاب، إذا خصّبت البيضة بوسائل "عادية" ثم حفزت على الانقسام، هل يعتبر هذا الإجراء انتهاكاً للحياة لأنه بتقسيم الواحد إلى اثنين تقسم الروح؟ وكيف يختلف ذلك عما يحدث في التوأمة الطبيعية؟ ماذا لو تدخّل الفني لاستحداث توأمين مما يجب أن يكون واحداً ثم جمّد أحد "التوأمين" ليوم لاحق، وبالتالي إحداث توأمين بينهما فاصل زمني – كما يفعل الاستنساخ؟ هل ذلك مختلف، وهل هو أسوأ من حيث الموضوع من التوأمة الطبيعية؟ ما هي القضية التي تواجه هنا بالضبط؟
هذه الأسئلة خاطئة بالنسبة لمن لا يتصوّرون أن حياة شخص فرد تبدأ بطريقة ذات مغزى عند الإخصاب. لكنها أسئلة مشروعة ومهمة بالنسبة إلى من يعتقدون أن الحياة تبدأ حتماً ومن دون أي شك عند اجتماع بيضة ونطفة.
عليهم أن يسألوا على سبيل المثال، كما سأل غلن ماكغي وأرثر كابلان، "ماذا يوجد في الطبق" في عيادات الإخصاب إذا لم يكن حياة لأنه خُلّق بطريقة مختلفة؟ على من يبدؤون بمثل هذه الاعتقادات ألا يتظاهروا بأنهم يتوسّلون أي حقيقة بيولوجية لدعم ادّعاءاتهم.
بل يجب أن يكون لاعتقاداتهم أسس أخرى، بعضها خارج المصدر الذي يعكس مسائل اصطلاح الناس الذي يحاولون التوصّل إليه. وهذه أسئلة عادلة وعميقة لنا جميعاً. فالاستنساخ يصيب كثيراً مما نؤمن به باعتزاز في الصميم.
تأتي ثانياً مجموعة من المخاوف بشأن كبرياء العالِم الذي يجري مثل هذه التجارب. هل كان العلماء الذي استحدثوا "دولي" يؤدّون دور الإله بطريقة غير مقبولة بالمرة لأنهم تدخّلوا في الطبيعة؟ هل كانوا ينتهكون حدود الطبيعة ما يوقعنا في مشاكل؟
يتناول عالم الإنجاب روجر غوسدن (Roger Gosden) هذا القلق في سياق أوسع من التغيّرات والتحدّيات الإنجابية على العموم، ويقدّم طائفة من الآمال والمخاوف بالإضافة إلى التوقّعات الطبية. هل يهتم أحد حقاً بشأن الخراف، أو هل نشعر أنه من غير المقبول أن يفعل في البشر ما فعله ويلموت وفريقه في الخراف؟ أصبح بعض هذه الأسئلة مخاوف عملية وفلسفية أيضاً، إذ ليس من الأخلاقي فعل أشياء في البشر لسنا واثقين من سلامتها.
وقد قدّم اختصاصي البيولوجيا الجزيئية رودولف جانيش (Rudolf Jaenisch) وإيان ويلموت هذه المقولة عندما كتبا أن "محاولات استنساخ كائنات بشرية فيما لم تتضح القضايا العلمية للاستنساخ النووي أمر خطير وغير مقبول".
بالإضافة إلى ذلك، هل ينطوي الاستنساخ على انتهاك لبعض الحدود التطورية الطبيعية؟ وهل تجلب مثل هذه الانتهاكات مخاطر كبيرة مثل مرض غير متوقّع أو تشوّهات أو تدرّك لمجموع الجينات. وفي حين أن المناقشات الأخلاقية المتعلّقة بمشروع الجينوم البشري تركّزت على مسائل مثل إذا ما كنا نقوم بمزج الجينات بطرق غير مقبولة وشديدة المخاطر، فقد تركّز السؤال هنا على ما إذا كان من غير الأخلاقي والخطير مزج الجينات أصلاً.
فخلافاً للتوالد الجنسي السوي للبشر، وهو يجمع الإسهامات الجينية من والدّين، مختلفين ويترك للمزيج القيام بالعملية التطورية، فإن الاستنساخ ينقل المساهمة الجينية من والد بصورة مباشرة تقريباً وسليمة إلى الذرية.
ويبدو الاستنساخ "غير طبيعي" وربما خطيراً إذا أدى إلى شذوذات وعيوب، وبخاصة إذا كان المانح من عمر مختلف كثيراً عن عمر خلية البيضة المضيفة، كما يحدث عند نقل الخلايا الجسدية من بالغ.
أثار آخرون قضايا العدالة الاجتماعية، وكثير منها أثير بشأن الجينوميات. إذا استثمرنا أموالاً عامة كثيرة في مشروع علمي، فكيف ستعود الفائدة على الجمهور؟ ماذا يمكننا أن نفعل بهذه الأموال غير ذلك؟ هذه إحدى الحجج المضادّة لتمويل مثل هذه البحوث، لكنها ليست مضادة للبحوث نفسها. ولاحظ آخرون أنه عندما نطوّر تقنيات وإجراءات طبية مكلفة جداً وتقتصر على قلّة بالضرورة، فسيكون هناك فرصة غير متكافئة للحصول على هذه "السلع". ويثير ذلك قضايا العدالة التوزيعية التي تنطبق على أي تقدّم تقني ولا تقتصر على الاستنساخ.
ثمة كثير من الأصوات، لكن يقدّم فيليب كيتشر ورونالد غرين وجهات نظر مختلفة جداً وعميقة التفكير بشأن قضايا العدالة الاجتماعية والحقوق في مجتمع ديمقرطي يواجه ابتكارات علمية وتكنولوجية. يشير غرين إلى ما يرى أنه حقّ مشروع للأزواج في إنجاب أطفال، ويحضّ على ألا نغلق الخيارات أمامهم على الأقل بسبب أهداف أخلاقية غامضة وغير مستدامة في النهاية. ويدعو إلى النظر في مصالحهم وألا ندع المطالب الجائرة للجماعات المؤيّدة للحياة تمنع هذا الخيار.
ويقدّم كيتشر حججاً قوية على أن ردّنا المشوّش على الاستنساخ يعكس فشلاً كبيراً في تطوير أي سياسات توجيهية أو توجيهات أخلاقية واضحة. ويشكّل وضع مثل هذه السياسات التوجيهية المراعية للآخرين والذكية تحدياً، وبخاصة مع التقدّم العلمي الغريب عن معظم صانعي السياسات.
وكما عبّر كيتشر عن ذلك، فإن واجبنا الأخلاقي تحسين حياة الناس ووضع سياسة اجتماعية حكيمة للقيام بذلك. ويخلص إلى أن "المعيب حقاً ليس أن الردّ على احتمالات الاستنساخ جاء متأخّراً، أو أنه ملتبس. بل يكمن في الإحجام الشائع لجميع الأمم الغنية عن التفكير في عواقب المبادئ التي تحظى باحترام منذ مدة طويلة وتصميم استخدام متماسك للمعلومات والتكنولوجيا الوراثية الجديدة من أجل صالح البشر".
تبيّن أن المطالبات الدستورية بالحقوق غريبة ومثيرة للاهتمام. فقد أصدرت الجبهة الموحّدة لحقوق الاستنساخ بيانات تشير إلى أن ليس للحكومة شأن للتدخّل في الحقوق الإنجابية للأفراد. وأصرّت على أن هذه الحقوق تشمل الاستنساخ.
من الواضح أنه لا يوجد فقرة في الدستور تنص على أن لكل فرد أميركي "الحق بالاستنساخ" أو حتى "الحقّ بالإنجاب". مع ذلك فإن الأحكام السابقة تمسكت بالحق الفعلي للأفراد بأن يكون لديهم سيطرة فردية كبيرة على الإنجاب، بما في ذلك بعض الحالات المتعلّقة بتحديد النسل والإجهاض التي بحثت من قبل.
الآن بعد أن أقرّت بعض الولايات، بقيادة كاليفورنيا، تشريعاً يحظر الاستنساخ مع السماح ببحوث الخلايا الجذعية، فإن من المرجّح أن نشهد دعاوي مرفوعة لتحدّي هذه القوانين والسعي للحماية. لكن في غياب تشريع اتحادي أو تفسير قانوني واضح، فإن الأسئلة القانونية تبقى في المستقبل إلى حدٍّ كبير. ويرجع الفضل إلى علماء القانون الدستوري لأنهم أثاروا الأسئلة القانونية ودعوا إلى نقاش تأملّي قائم على المعلومات باعتباره مسألة تتعلّق بالفقه القانوني بدلاً من انتظار الوقت الذي يتعيّن علينا أن نصدر فيه أحكاماً بشأن انتهاكات قوانين معينة.
إن الردّ الشعبي على الاستنساخ موروث من مشروع الجينوم البشري. وقد أنفق كثير من الوقت والجهد، من خلال العديد من المؤتمرات وورش العمل، على قضايا أخلاقية وقانونية تتعلّق بعلم الوراثة بحيث نخاطر بتشويه فهمنا لأنفسنا وإحساسنا بما تكون عليه، أو يجب أن تكون عليه، الحياة الفردية.
عند النظر في مشروع الجينوم وعواقبه على "الوراثيات الإنجابية"، بالإضافة إلى الاستنساخ وبحوث الخلايا الجذعية والتدخّلات البيولوجية ذات الصلة التي تشتمل على البيوض البشرية، فإن الجماعات النسائية تشير على نحو متزايد إلى الإساءة للنساء واستغلالهن.
وما دام هناك سوق كبيرة للبيوض البشرية وما دام يسمح للنساء ببيع البيوض، فستكون هناك إغراءات لاستمالتهن إلى بيعها إن لم يكن إجبارهن على ذلك. غير أن علينا العمل ضد انعدامات التوازن هذه من دون وقف التطوّر التقني.
ما هي قيمة البيضة؟ أو الحياة؟ وما هي الحياة الجيدة التي تحظى بتقدير؟ يبدو أن الاستنساخ يتحدّى مفهومنا للحياة وما هو جيد، أو ربما يبدو كذلك فقط لأننا لم نتأمّل بالقدر الكافي في ما نقدّره. لا شك في أن بعض من علّق على الاستنساخ كانوا متلهّفين جداً للقفز إلى الاستنتاجات من خلال المحدّدات الوراثية والجينوميات وتجاهل عملية التمايز بالتخلّق المتوالي (Epigenetic Differentiation).
وتشير تفسيراتهم إلى مخاطر الاندفاع نحو الاستنتاجات العلمية أو الأخلاقية في غياب الفهم الأعمق للسياق. لقد كتب الشاعر ت. س. إليوت (T. S. Eliot):
أين الحياة التي خسرناها ونحن نعيشها؟
أين الحكمة التي خسرناها في المعرفة؟
أين المعرفة التي خسرناها في المعلومات؟
يبدو أن هذه الأبيات المأخوذة من مسرحية الصخرة (The Rock, 1934) تلتقط تحسّرات عصرنا الحديث ببراعة بحيث تُقتبس على نطاق واسع. فقد حدّد بحث واحد على الإنترنت 477 اقتباساً لهذه القطعة بالضبط، بمثابة افتتاحية لمؤتمرات عن تكنولوجيا المعلومات مثلاً، أو بمثابة توقّع لعصر المعلومات كما تنبأ به الألمعي إليوت.
يبدو أن إليوت يخبرنا أن علينا ألا نتوه في المعلومات لكن علينا الاحتفاظ بشعور أكبر بالحياة، والحكمة، والمعرفة. إنه يتألّم من أن النشاط الدائم ترك الإنسان "بعيداً عن الله" ولكن قريباً من "التراب". ربما يكون القرب من التراب، ومن الطبيعة ضمناً، أمراً جيداً. إنني أجده كذلك. لكن علينا أن نسأل على الأقل ما المصلحة من السعي وراء المعرفة، وما الغاية التي نعيش من أجلها؟ ما هي الحياة التي نقدّرها، وما هي الحياة التي نعتزّ بها، وماذا يعني أن نعيش حياة جيدة تحظى بتقدير؟ ربما يفيدنا سعينا وراء "حلقة لا نهائية من الفكر والعمل، والاختراعات التي لا نهاية لها، والتجارب التي لا نهاية لها". لكن علينا على الأقل أن نتصدّى لهذه الأسئلة.
إذا وافقنا على دعوة سقراط إلى التأمّل في الخير وتفحّصه، وبالتالي جعل الحياة أكثر جدارة لأن تُحيا، فإن من الأمور التي يجب أن تبلغنا عنها تأمّلاتنا الأخلاقية أننا بعيدون جداً عن تحديد الحياة أو حتى تقرير متى تبدأ.
كما أننا بعيدون جداً عن امتلاك سياسات أو حتى ممارسات ذكية لتطوير السياسات التي يرجّح أن تقودنا إلى اتخاذ قرارات حكيمة. إننا بدلاً من ذلك نعتمد على أهواء ردّ الفعل وصخب صنع السياسات من خلال حلقة لا نهائية من ردود الأفعال على الأحداث الحالية والخطابات والضغوط ومشاريع القوانين والتعديلات والرفض والدحض وما إلى هناك.
[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]